عبدالكريم سروش وإعادة الاعتبار للأشعرية - د. هيثم مزاحم
عبدالكريم سروش وإعادة الاعتبار للأشعرية
السبت, 12 نوفمبر 2011
هيثم مزاحم *
ألقى المفكر الإيراني الإصلاحي عبدالكريم سروش محاضرة قبل سنوات بعنوان «الكلام الإسلامي بين نزعة الاعتزال العقلية ومذهب الأشعرية التجريبية»، نقلها إلى العربية الشيخ حيدر حب الله في مجلة نصوص معاصرة، العدد الرابع. سروش يعيد قراءة المذهب الكلامي الأشعري والسجال الأشعري – المعتزلي ويردّ الاعتبار للأشعرية، من منطلق فلسفي وعلمي حديث ومقارن، وليس من منطلقات تاريخية ومذهبية ضيقة.
ومعلوم أن تاريخ الثقافة الإسلامية شهد ظهور مدرستين كلاميتين كبيرتين هما: المعتزلة والأشاعرة، ارتبط أهل السنة لاحقاً بالمذهب الأشعري في العقائد، على رغم أن المعتزلة كانوا يضمون مفكرين ومتكلمين من مختلف المذاهب الفقهية (سنة، وشيعة إثني عشرية، وزيدية)، إلا أن الشيعة قد تبنّوا الكثير من أفكار المعتزلة، وبخاصة في التوحيد والعدل، والحسن والقبح الذاتيين والعقليين. بينما ورث أنصار الزيدية تراث المعتزلة وحفظوه من الاندثار. يقول سروش: «على رغم ما قيل عن استقلال الشيعة آنذاك بمذهب كلامي، فإنّ هذا المذهب كانت تربطه بمدرسة الاعتزال أواصر من القرابة».
في محاضرته المميّزة عرض سروش جوهر الخلافات بين الأشاعرة والمعتزلة وكيف ظهر العقل الاعتزالي، وهو لا يتسنّى عرضه هنا، فضلاً عن كونه موجوداً في الكتب المختصة بنشأة علم الكلام الإسلامي وتاريخه. لقد كان الكلام المعتزلي مقدّماً على الكلام الأشعري، لكن دولته كانت قصيرة الأمد، فلم تدم سوى قرن واحد أو أقل؛ إذ عصفت الأحداث السياسية والكلامية بالمعتزلة ونحّتهم جانباً؛ فتحوّلوا من حركة مهيمنة في تاريخ الإسلام إلى أخرى مغلوبة. يقول سروش: «لو لم يكن للشيعة وجود فإن حال الكلام المعتزلي كان أسوأ من ذلك بكثير. ولا يوجد بين أيدينا اليوم من كُتُب المعتزلة شيء، فما نعرفه عنهم أنما هو ما بقي قابعاً داخل الردود التي تلقاها الاعتزال، فالأشاعرة نقلوا آراء المعتزلة ثم أردفوها بالنقد والتفنيد، إلا أن هذه المنقولات عن المعتزلة كانت دائماً مختصرةً موجزةً، حتى أنهم لم ينقلوا لنا في رأي من آراء المعتزلة عبارة مؤلفي الاعتزال ومتكلّميه، إنما كانوا يكتفون فقط بنسبة الرأي إليهم، أما إلى أيّ حدّ كان ذلك في سياقه (contexte)، وإلى أي مدى كانوا أوفياء بهذا النقل، صادقين فيه، مستوفينه في شكل كامل، فهذا ما يحتاج بدوره إلى بحث ومتابعة».
لقد ظهر للمعتزلة أواخر حياتهم أنصار في بلاد اليمن، وقد عثر على بعضٍ من أفضل وأهم كتبهم في تلك الديار، وطبعت تلك الكتب خلال العقود الأربعة الماضية، لتوضع في متناول الباحثين وأهل الرأي، ولا بدّ من الرجوع إلى النصوص الأصلية للمعتزلة. ولا بدّ من التذكير بأن البحث في سرّ انهيار دولة المعتزلة مع الخليفة العباسي المأمون، لا تزال واحدةً من مسائل التاريخ الإسلامي المثيرة. رُوي أن أحداث محنة الإمام أحمد بن حنبل، تلك التي أقامها المعتزلة بمساعدة ودعم الواثق بالله والمأمون وآخرين أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث، كانت من فجائع التاريخ الإسلامي، وقد كانت سبباً في انقلاب المسلمين عليهم، وسبباً لنفوذهم في ميدان الخلافة والسياسة ليختموا تدخلهم هذا بالإطاحة بالاعتزال وتنحيته؛ إذ كان المأمون معتزلياً، بل كان واحداً من متكلّميهم. وتجلّى الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة آنذاك بمسألة خلق القرآن أو قدمه. وكان الجهاز المحيط بالمأمون والواثق بالله يمتحن علماء المسلمين ويسألوهم: هل تقولون بقدم كلام الله أو بحدوثه؟
كان المعتزلة قائلين بحدوث الكلام الإلهي، ولهذا أخرجوا كلّ أولئك الذين ذهبوا إلى القول بقدم الكلام ونحّوهم جانباً، وأبدى الإمام أحمد بن حنبل ممانعةً في الاعتراف بحدوث الكلام، وظلّ مصرّاً على القول بقدمه، حتى سجن، وهكذا وقعت أحداث سيئة للغاية في عصر المحنة هذا.
ويشير سروش إلى أن بعض المؤرخين المعاصرين يرفضون الاتهامات الموجهة إلى المعتزلة، ولا يرونها صحيحةً، ويعدّ الباحث الأردني فهمي جدعان، واحداً من أولئك. فقد استدلّ في كتابه المحنة -وبجدارة- على عدم صحّة هذه التهمة الموجهة إلى المعتزلة، وعلى أن الأحداث كانت أعقد بكثير مما قيل عنها، وهو يرفض كلياً المزاعم التي تتحدث عن الجلسات الامتحانية التي كان يعقدها المعتزلة.
وأسس أبو الحسن الأشعري، بعد حقبةٍ من الاعتزال، مذهب الأشعرية، ذلك المذهب الذي تحوّل في ما بعد إلى مذهب جمهور المسلمين، الذي هيمن على المسلمين اثني عشر قرناً، أي منذ نهايات القرن الثاني الهجري وإلى عصرنا اليوم. يقول سروش: «إن عامّة الكبار والعظماء الذين نعرفهم في العالم السنّي كانوا جميعهم من الأشاعرة، مثل الفخر الرازي، والمولوي جلال الدين الرومي، والغزالي، وإمام الحرمين الجويني و...». ويرى سروش أن الأشعرية لم تبقَ على حالها كما بدأت، فإذا ما قارنا أشعرية القرن السابع الهجري كما جاءت في كتاب «المواقف» بأشعرية القرن الثاني، لرأينا أنها غدت أكثر اختماراً ونضجاً من سابقتها، بل لقد دمجت بعض مواقفها لاحقاً بالمواقف الاعتزالية، وأخذت طابعاً فلسفياً.
مسألة الحسن والقبح
لقد ظهر المعتزلة في العالم الإسلامي قبل دخول الفكر اليوناني إليه، فقد كانت الكتب اليونانية تحت الترجمة، وكان اطلاع المسلمين على الفكر الفلسفي اليوناني في بداياته الأولى، لكن المصطلحات المعادلة للمصطلح الفلسفي اليوناني لم تكن قد ظهرت بعد أو تبلوّرت. ويطرح سروش مثالاً هو مسألة الحسن والقبح الذاتيين في الأخلاق ويرى أن من غير الأكيد ما إذا كان مصطلح الذاتي هنا في الثقافة الإسلامية يطابق مصطلح الذاتي في الفلسفة اليونانية، فهذه الكلمات لم تكن في ذلك الزمان قد أخذت بُعدها الاصطلاحي، إذ مضت مدّة حتى استطاع المسلمون تأسيس مدرسة فلسفية تحمل في طياتها مصطلحات معادلة لتلك التي في الفلسفة اليونانية.
ويطلق سروش على المعتزلة المدرسة الدينية غير التجربية، في مقابل المدرسة الأشعرية التي يعتبرها مدرسةً تجربيةً دينية أو تجربيةً نقلية، فالأشاعرة في المواقف التي اتخذوها كانوا أقرب إلى التجربيين الجدد. أما المعتزلة فكانوا على النقيض من ذلك تماماً، أي لم يكونوا تجربيين، بل منشغلين في شكل أكبر في داخل المقولات العقلية القَبلية.
ومنذ بداية تكوّن الفلسفة كانت هناك مدرستان متعارضتان، ولا تزالان حتى الوقت الحاضر، المدرسة الأولى هي التي تهدف إلى إخضاع عالم الطبيعة وما بعد الطبيعة لنظام المقولات العقلية القَبلية، بغية تفسيرهما وفقاً لتلك المقولات، وبعبارةٍ بالغة البساطة: إنها مدرسة تنظر إلى العالم من الأعلى، وترسم له خريطةً عقلانية، وهي خريطة تظهر قبل ممارسة التجربة أو الرجوع إلى هذا العالَم نفسه.
ويشرح سروش أن هذه المدرسة ترسم خريطةً عقلانية قبلية في عقول أصحابها قبل أن يقتحموا ميدان التجربة، ثم يسقطون هذه المنظومة التصوّرية المنتجة على العالم نفسه، ساعين قصارى جهدهم لإيجاد بنية توليفية تعيد ربط حوادث العالم المتفرّقة المشتتة في ظلّ هذه الخريطة القبلية وعلى ضوئها؛ بغية تفسير هذا العالم برمّته. ويضرب مثالاً على ذلك مبدأ العلية، فالحكماء يعتقدون أن هذا المبدأ لم يتمّ استقاؤه من العالم الخارجي، وهو أمر متفق عليه بين الفلاسفة التجربيين وفلاسفة الميتافيزيقا، فبمشاهدة حوادث هذا العالم لا يمكنك أبداً استنتاج مبدأ يسمّى بمبدأ العلية، فيبقى التساؤل التالي مثاراً: من أين أتينا بهذا المبدأ؟ لنفرض أنه مبدأ متصل ببنيتنا العقلية أو لنفرض أنه معطى شهودي كشفي، منحنا الله إياه ووفقنا للوصول إليه، لكن على أيّ حال، ومهما كان هذا المبدأ، فإننا نسقطه على هذا العالم إسقاطاً، ثم نسعى لتحليل الوجود على أساسه، هذا هو ما نسمّيه الفلسفات القَبلية، والتي منها الفلسفة الإسلامية، والفلسفة الكانطية، والفلسفة الأرسطية، والفلسفة الأفلاطونية. فهذه الفلسفات جميعها تنظر إلى هذا العالم من الأعلى وفقاً لخريطة مسبقة.
المدرسة الثانية: وتمثل مجموعةً أخرى من الفلسفات، لا بدّ لنا أن نسمّيها بالفلسفات البَعدية، ومعنى البعدية أنها ترسم خريطة العالم عقب رجوعها إليه ونظرها في ظواهره وأحداثه، لتمارس بعد ذلك -وتدريجاً- إكمالاً لخريطتها وتتميماً لها على ضوء هذه المراجعة المتواصلة المكرورة.
المثال الأكثر وضوحاً من مثال العلية هو مثال الكلّيات، فهذا البحث -من وجهة نظر سروش- واحد من الأبحاث الفلسفية الفائقة الأهمية، ذلك أن الحياة الإسلامية لم تشهد على الإطلاق مدرسةً باسم المدرسة الاسمية، ولهذا نواجه اليوم معضلة ومشكلةً في ترجمة هذه المفردة عن أصلها الأوّلي، ولفقدان معادل لها تمّت الاستفادة من كلمة الاسميون. يذهب عامّة فلاسفتنا إلى القول بوجود الكليات أو (universals)، أي أنهم قائلون بالماهية، وبالكلي الطبيعي، وبالذات، لقد كانوا يعتبرون الموجودات الخارجية مصاديق للكلّي الطبيعي، ويتحدّثون عن مفهوم كلّي اسمه: الإنسان أو النبات، وأن ما في العالم الخارجي ليس سوى مصاديق لهذا المفهوم الكلّي، وأننا إنما نقوم بإسقاط هذا المعنى الكلّي على مصاديقه، وتطبيقه عليها.
أمّا المدرسة التجربية، أو في الحقيقة المدرسة الاسمية، فترى أن ما لدينا ليس سوى أفراد الإنسان، وأننا نحن من يقوم بضمّ هذه الأفراد إلى جانب بعضها ثم ممارسة جمع وضم لها، والأثر الناتج من هذا الجمع هو الوصول إلى عنصر مشترك، نسمّيه «الكلّي». ألا وهو الإنسان، فالحركة في هذه الفلسفة البعدية - التجربية حركة من الأسفل إلى الأعلى، أي حركة نحو جمع المشاهدات لرسم خريطة العالم بصورةٍ تدريجية، لكن ضمن قوالب كلية.
إذاً يقترب المعتزلة أكثر من الفلسفات القبلية، لذا كانت المدرسة الاعتزالية أقلّ تجربيةً، لكن الأشاعرة على الطرف المقابل كانوا على العكس من ذلك تماماً، إذ كانوا أقرب إلى الفلسفات البعدية، وأكثر تجريبيةً أيضاً. ويستدرك سروش أنه يتعرّض لهذا الموضوع في المحاضرة بشيء من الإبهام والإجمال عمداً، لأنه لا يغطي تمام المواقف الاعتزالية والأشعرية، إذ حصلت في الطرفين تحوّلات جادة وتغيّرات لافتة.
ويطرح سروش مثالاً بسيطاً عن الخلاف بين المدرستين، فثمة نزاع فرعي وقع بين الأشاعرة والمعتزلة يدور حول هل الرزق يطلق فقط على الحلال منه أم أن مفهومه يعمّ الحلال منه والحرام؟ فهل الدخل الشخصي لفردٍ ما يسمّى رزقاً إذا كان مطابقاً للقوانين الأعم من الفقهية والعرفية، ومنطلقاً من الكسب الحلال والمشروع أم أن الدخل الشخصي يسمّى كذلك حتى لو أتى من أيّ سبيل كالغصب والسرقة، والمعاملات غير السليمة الخ.. فأيّ من هذين الرأيين في مسألة الرزق أقرب إلى الموقف الأشعري وأيّهما إلى الموقف الاعتزالي؟
يجيب سروش: إن المعتزلة يذهبون إلى أن الرزق هو الحلال فقط، فيما يعمّمه الأشاعرة إلى الحلال والحرام. فإذا كانت لدينا قراءة بَعدية تجريبية بعيدة عن المعايير المسبقة التي لا نريد إقحامها في الحكم، وهي معايير عيّنت سلفاً الحلال والحرام، فإننا سنقول: الدخل الاقتصادي يعمّ الحلال منه والحرام، بل ويشمل الملفّق منهما تماماً كما قال الأشاعرة. أما لو أردنا النظر من الأعلى إلى هذا الموضوع، وهدِفنا الشروع من التعاريف والكلّيات، وأردنا تحديد وظائف الأشياء من منطلق عالم العقل والتعريف، ثم ممارسة حركة توفيقية بين ما توصّلنا إليه وما هو في العالم الخارجي، فإننا سوف نعرّف الرزق في البداية، ثم نقوم باختيار ما يأتي تحت هذا التعريف من مصاديق له في الخارج، لنقصي البقية عقب ذلك.
من هنا يصل سروش إلى مسألةٍ أكثر جديةً ترتبط باختلاف وجهات النظر بين الأشاعرة والمعتزلة، هي مسألة الحسن والقبح الذاتيين أو الحسن والقبح العقليين. فعندما يقول المعتزلة: إن الفعل الفلاني له حسن وقبح ذاتيان، فإنهم يعنون أن هذا الفعل إما حسن أو قبيح، بمعنى أن العقل -في مقام الإثبات أو المعرفة- يمكنه أن ينتقي أحدها ويلغي الآخر.
كان الأشاعرة ينظرون إلى التجربة العملية ونتائجها المباشرة، فيقولون: إن الكذب قبيح لأنه يحمل مضارّ في الجانب العملي والتجريبي، فيما يقابل الصدقُ الحسنَ؛ لأنه ذو فوائد عملية وتجريبية، وهذا الموقف موقفٌ تجريبي عملاني، وعلم الأخلاق الذي يتجه اليوم إلى التجريبية يمرّ تقريباً عبر هذا المسير.
ثم يبحث سروش في مسألة الكليات ويذهب إلى أن المدرسة الأشعرية عموماً مدرسة اسمية، أي الذين يقصرون نظرهم على الأفراد ثم يقومون بجمعها لينالوا -عبر ذلك- الحكم الكلّي.
بحث العلية
وهناك مثالٌ أكثر دلالةً، ألا وهو بحث العلية، فالأشاعرة غير قائلين بالعلية العرضية والطبيعية في هذا العالم، وهذا بالضبط موقف تجريبي في مسألة العلية، ويدعو سروش إلى مراجعة كتاب «مقاصد الفلاسفة» أو «تهافت الفلاسفة» للغزالي، لكي نرى كيف شيّد -وبقوّة وبلاغة- أدلّة نقد مبدأ العلية. إن أدلّة الغزالي كانت قريبةً جداً من أدلّة ديفيد هيوم. نعم، هناك فرق بين رأي الغزالي في هذا الموضوع ورأي هيوم، إذ يعتقد الأخير بعدم مفهومية علاقة الضرورة (Necessary Connection)، بل إن هذه الكلمة فاقدة للمعنى أساساً، فلا وجود لشيء اسمه الربط الضروري أو علاقة الضرورة. أما الغزالي فينفي وجود علاقة العلية في الخارج، وهذا هو ما ينتج القول بالتقارن، ذلك أننا لا نرى في هذا العالم سوى مقارنات وتوالي أحداث، وهذه المقارنات والمتواليات لو حدثت آلاف المرات فلن يمكنها أن تنتج وجود علاقة ربط ضروري بين أطرافها، ذاك الربط الذي يسمّى بمبدأ العلية.
والفلاسفة التجريبيون لا يقولون أكثر من هذا، بل إن الفلاسفة العقليين أنفسهم لا يرون أصل العلية نتاجاً لعملية تجربية بحتة، أما مبدأ العلية فقد أتى من خريطة مسبقة مرسومة عقلاً أسقطت على هذا العالم. يصرّح الأشاعرة بأن ما نراه في هذا العالم ليس عليّةً أو سببية، فهم يرجعون العلية لله سبحانه. كما يطرح سروش مسائل خلافية أخرى مثل قانون الترجيح بلا مرجح، ومعضلة العدل الإلهي، وغرضية الفعل الإلهي، ومقولة الجزء الذي لا يتجزأ، وإنكار الكرامات، وهي مسائل تحتاج إلى مناقشة مستقلة ومستفيضة.
ويخلص سروش إلى أن لدى المعتزلة نوعاً من المماهاة للإنسان وبلوّرة الأشياء وفقه، وبتعبير آخر أنسنة العالم، وعلى حدّ تعبير أحمد آرام: اعتبار الإنسان مقياساً والحساب عليه. فإذا ما اعتبرنا الله سبحانه مثل الإنسان تقريباً، وأفعاله كتلك الصادرة من الفاعل الإنساني، ثم رتبنا الأحكام الأخلاقية وغير الأخلاقية للإنسان عليها، عندئذٍ سوف تبدو بوضوح أكبر صعوبة الموقف وتعقيداته، ولهذا، يعتقد سروش أن فصل المذهب الاعتزالي عن الإنسانوية، ثم مصالحته مع النزعة التجريبية، سوف يساعد على تحوّله إلى مدرسةٍ مقبولة في عالمنا اليوم.
* باحث في الفكر العربي والإسلامي
السبت, 12 نوفمبر 2011
هيثم مزاحم *
ألقى المفكر الإيراني الإصلاحي عبدالكريم سروش محاضرة قبل سنوات بعنوان «الكلام الإسلامي بين نزعة الاعتزال العقلية ومذهب الأشعرية التجريبية»، نقلها إلى العربية الشيخ حيدر حب الله في مجلة نصوص معاصرة، العدد الرابع. سروش يعيد قراءة المذهب الكلامي الأشعري والسجال الأشعري – المعتزلي ويردّ الاعتبار للأشعرية، من منطلق فلسفي وعلمي حديث ومقارن، وليس من منطلقات تاريخية ومذهبية ضيقة.
ومعلوم أن تاريخ الثقافة الإسلامية شهد ظهور مدرستين كلاميتين كبيرتين هما: المعتزلة والأشاعرة، ارتبط أهل السنة لاحقاً بالمذهب الأشعري في العقائد، على رغم أن المعتزلة كانوا يضمون مفكرين ومتكلمين من مختلف المذاهب الفقهية (سنة، وشيعة إثني عشرية، وزيدية)، إلا أن الشيعة قد تبنّوا الكثير من أفكار المعتزلة، وبخاصة في التوحيد والعدل، والحسن والقبح الذاتيين والعقليين. بينما ورث أنصار الزيدية تراث المعتزلة وحفظوه من الاندثار. يقول سروش: «على رغم ما قيل عن استقلال الشيعة آنذاك بمذهب كلامي، فإنّ هذا المذهب كانت تربطه بمدرسة الاعتزال أواصر من القرابة».
في محاضرته المميّزة عرض سروش جوهر الخلافات بين الأشاعرة والمعتزلة وكيف ظهر العقل الاعتزالي، وهو لا يتسنّى عرضه هنا، فضلاً عن كونه موجوداً في الكتب المختصة بنشأة علم الكلام الإسلامي وتاريخه. لقد كان الكلام المعتزلي مقدّماً على الكلام الأشعري، لكن دولته كانت قصيرة الأمد، فلم تدم سوى قرن واحد أو أقل؛ إذ عصفت الأحداث السياسية والكلامية بالمعتزلة ونحّتهم جانباً؛ فتحوّلوا من حركة مهيمنة في تاريخ الإسلام إلى أخرى مغلوبة. يقول سروش: «لو لم يكن للشيعة وجود فإن حال الكلام المعتزلي كان أسوأ من ذلك بكثير. ولا يوجد بين أيدينا اليوم من كُتُب المعتزلة شيء، فما نعرفه عنهم أنما هو ما بقي قابعاً داخل الردود التي تلقاها الاعتزال، فالأشاعرة نقلوا آراء المعتزلة ثم أردفوها بالنقد والتفنيد، إلا أن هذه المنقولات عن المعتزلة كانت دائماً مختصرةً موجزةً، حتى أنهم لم ينقلوا لنا في رأي من آراء المعتزلة عبارة مؤلفي الاعتزال ومتكلّميه، إنما كانوا يكتفون فقط بنسبة الرأي إليهم، أما إلى أيّ حدّ كان ذلك في سياقه (contexte)، وإلى أي مدى كانوا أوفياء بهذا النقل، صادقين فيه، مستوفينه في شكل كامل، فهذا ما يحتاج بدوره إلى بحث ومتابعة».
لقد ظهر للمعتزلة أواخر حياتهم أنصار في بلاد اليمن، وقد عثر على بعضٍ من أفضل وأهم كتبهم في تلك الديار، وطبعت تلك الكتب خلال العقود الأربعة الماضية، لتوضع في متناول الباحثين وأهل الرأي، ولا بدّ من الرجوع إلى النصوص الأصلية للمعتزلة. ولا بدّ من التذكير بأن البحث في سرّ انهيار دولة المعتزلة مع الخليفة العباسي المأمون، لا تزال واحدةً من مسائل التاريخ الإسلامي المثيرة. رُوي أن أحداث محنة الإمام أحمد بن حنبل، تلك التي أقامها المعتزلة بمساعدة ودعم الواثق بالله والمأمون وآخرين أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث، كانت من فجائع التاريخ الإسلامي، وقد كانت سبباً في انقلاب المسلمين عليهم، وسبباً لنفوذهم في ميدان الخلافة والسياسة ليختموا تدخلهم هذا بالإطاحة بالاعتزال وتنحيته؛ إذ كان المأمون معتزلياً، بل كان واحداً من متكلّميهم. وتجلّى الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة آنذاك بمسألة خلق القرآن أو قدمه. وكان الجهاز المحيط بالمأمون والواثق بالله يمتحن علماء المسلمين ويسألوهم: هل تقولون بقدم كلام الله أو بحدوثه؟
كان المعتزلة قائلين بحدوث الكلام الإلهي، ولهذا أخرجوا كلّ أولئك الذين ذهبوا إلى القول بقدم الكلام ونحّوهم جانباً، وأبدى الإمام أحمد بن حنبل ممانعةً في الاعتراف بحدوث الكلام، وظلّ مصرّاً على القول بقدمه، حتى سجن، وهكذا وقعت أحداث سيئة للغاية في عصر المحنة هذا.
ويشير سروش إلى أن بعض المؤرخين المعاصرين يرفضون الاتهامات الموجهة إلى المعتزلة، ولا يرونها صحيحةً، ويعدّ الباحث الأردني فهمي جدعان، واحداً من أولئك. فقد استدلّ في كتابه المحنة -وبجدارة- على عدم صحّة هذه التهمة الموجهة إلى المعتزلة، وعلى أن الأحداث كانت أعقد بكثير مما قيل عنها، وهو يرفض كلياً المزاعم التي تتحدث عن الجلسات الامتحانية التي كان يعقدها المعتزلة.
وأسس أبو الحسن الأشعري، بعد حقبةٍ من الاعتزال، مذهب الأشعرية، ذلك المذهب الذي تحوّل في ما بعد إلى مذهب جمهور المسلمين، الذي هيمن على المسلمين اثني عشر قرناً، أي منذ نهايات القرن الثاني الهجري وإلى عصرنا اليوم. يقول سروش: «إن عامّة الكبار والعظماء الذين نعرفهم في العالم السنّي كانوا جميعهم من الأشاعرة، مثل الفخر الرازي، والمولوي جلال الدين الرومي، والغزالي، وإمام الحرمين الجويني و...». ويرى سروش أن الأشعرية لم تبقَ على حالها كما بدأت، فإذا ما قارنا أشعرية القرن السابع الهجري كما جاءت في كتاب «المواقف» بأشعرية القرن الثاني، لرأينا أنها غدت أكثر اختماراً ونضجاً من سابقتها، بل لقد دمجت بعض مواقفها لاحقاً بالمواقف الاعتزالية، وأخذت طابعاً فلسفياً.
مسألة الحسن والقبح
لقد ظهر المعتزلة في العالم الإسلامي قبل دخول الفكر اليوناني إليه، فقد كانت الكتب اليونانية تحت الترجمة، وكان اطلاع المسلمين على الفكر الفلسفي اليوناني في بداياته الأولى، لكن المصطلحات المعادلة للمصطلح الفلسفي اليوناني لم تكن قد ظهرت بعد أو تبلوّرت. ويطرح سروش مثالاً هو مسألة الحسن والقبح الذاتيين في الأخلاق ويرى أن من غير الأكيد ما إذا كان مصطلح الذاتي هنا في الثقافة الإسلامية يطابق مصطلح الذاتي في الفلسفة اليونانية، فهذه الكلمات لم تكن في ذلك الزمان قد أخذت بُعدها الاصطلاحي، إذ مضت مدّة حتى استطاع المسلمون تأسيس مدرسة فلسفية تحمل في طياتها مصطلحات معادلة لتلك التي في الفلسفة اليونانية.
ويطلق سروش على المعتزلة المدرسة الدينية غير التجربية، في مقابل المدرسة الأشعرية التي يعتبرها مدرسةً تجربيةً دينية أو تجربيةً نقلية، فالأشاعرة في المواقف التي اتخذوها كانوا أقرب إلى التجربيين الجدد. أما المعتزلة فكانوا على النقيض من ذلك تماماً، أي لم يكونوا تجربيين، بل منشغلين في شكل أكبر في داخل المقولات العقلية القَبلية.
ومنذ بداية تكوّن الفلسفة كانت هناك مدرستان متعارضتان، ولا تزالان حتى الوقت الحاضر، المدرسة الأولى هي التي تهدف إلى إخضاع عالم الطبيعة وما بعد الطبيعة لنظام المقولات العقلية القَبلية، بغية تفسيرهما وفقاً لتلك المقولات، وبعبارةٍ بالغة البساطة: إنها مدرسة تنظر إلى العالم من الأعلى، وترسم له خريطةً عقلانية، وهي خريطة تظهر قبل ممارسة التجربة أو الرجوع إلى هذا العالَم نفسه.
ويشرح سروش أن هذه المدرسة ترسم خريطةً عقلانية قبلية في عقول أصحابها قبل أن يقتحموا ميدان التجربة، ثم يسقطون هذه المنظومة التصوّرية المنتجة على العالم نفسه، ساعين قصارى جهدهم لإيجاد بنية توليفية تعيد ربط حوادث العالم المتفرّقة المشتتة في ظلّ هذه الخريطة القبلية وعلى ضوئها؛ بغية تفسير هذا العالم برمّته. ويضرب مثالاً على ذلك مبدأ العلية، فالحكماء يعتقدون أن هذا المبدأ لم يتمّ استقاؤه من العالم الخارجي، وهو أمر متفق عليه بين الفلاسفة التجربيين وفلاسفة الميتافيزيقا، فبمشاهدة حوادث هذا العالم لا يمكنك أبداً استنتاج مبدأ يسمّى بمبدأ العلية، فيبقى التساؤل التالي مثاراً: من أين أتينا بهذا المبدأ؟ لنفرض أنه مبدأ متصل ببنيتنا العقلية أو لنفرض أنه معطى شهودي كشفي، منحنا الله إياه ووفقنا للوصول إليه، لكن على أيّ حال، ومهما كان هذا المبدأ، فإننا نسقطه على هذا العالم إسقاطاً، ثم نسعى لتحليل الوجود على أساسه، هذا هو ما نسمّيه الفلسفات القَبلية، والتي منها الفلسفة الإسلامية، والفلسفة الكانطية، والفلسفة الأرسطية، والفلسفة الأفلاطونية. فهذه الفلسفات جميعها تنظر إلى هذا العالم من الأعلى وفقاً لخريطة مسبقة.
المدرسة الثانية: وتمثل مجموعةً أخرى من الفلسفات، لا بدّ لنا أن نسمّيها بالفلسفات البَعدية، ومعنى البعدية أنها ترسم خريطة العالم عقب رجوعها إليه ونظرها في ظواهره وأحداثه، لتمارس بعد ذلك -وتدريجاً- إكمالاً لخريطتها وتتميماً لها على ضوء هذه المراجعة المتواصلة المكرورة.
المثال الأكثر وضوحاً من مثال العلية هو مثال الكلّيات، فهذا البحث -من وجهة نظر سروش- واحد من الأبحاث الفلسفية الفائقة الأهمية، ذلك أن الحياة الإسلامية لم تشهد على الإطلاق مدرسةً باسم المدرسة الاسمية، ولهذا نواجه اليوم معضلة ومشكلةً في ترجمة هذه المفردة عن أصلها الأوّلي، ولفقدان معادل لها تمّت الاستفادة من كلمة الاسميون. يذهب عامّة فلاسفتنا إلى القول بوجود الكليات أو (universals)، أي أنهم قائلون بالماهية، وبالكلي الطبيعي، وبالذات، لقد كانوا يعتبرون الموجودات الخارجية مصاديق للكلّي الطبيعي، ويتحدّثون عن مفهوم كلّي اسمه: الإنسان أو النبات، وأن ما في العالم الخارجي ليس سوى مصاديق لهذا المفهوم الكلّي، وأننا إنما نقوم بإسقاط هذا المعنى الكلّي على مصاديقه، وتطبيقه عليها.
أمّا المدرسة التجربية، أو في الحقيقة المدرسة الاسمية، فترى أن ما لدينا ليس سوى أفراد الإنسان، وأننا نحن من يقوم بضمّ هذه الأفراد إلى جانب بعضها ثم ممارسة جمع وضم لها، والأثر الناتج من هذا الجمع هو الوصول إلى عنصر مشترك، نسمّيه «الكلّي». ألا وهو الإنسان، فالحركة في هذه الفلسفة البعدية - التجربية حركة من الأسفل إلى الأعلى، أي حركة نحو جمع المشاهدات لرسم خريطة العالم بصورةٍ تدريجية، لكن ضمن قوالب كلية.
إذاً يقترب المعتزلة أكثر من الفلسفات القبلية، لذا كانت المدرسة الاعتزالية أقلّ تجربيةً، لكن الأشاعرة على الطرف المقابل كانوا على العكس من ذلك تماماً، إذ كانوا أقرب إلى الفلسفات البعدية، وأكثر تجريبيةً أيضاً. ويستدرك سروش أنه يتعرّض لهذا الموضوع في المحاضرة بشيء من الإبهام والإجمال عمداً، لأنه لا يغطي تمام المواقف الاعتزالية والأشعرية، إذ حصلت في الطرفين تحوّلات جادة وتغيّرات لافتة.
ويطرح سروش مثالاً بسيطاً عن الخلاف بين المدرستين، فثمة نزاع فرعي وقع بين الأشاعرة والمعتزلة يدور حول هل الرزق يطلق فقط على الحلال منه أم أن مفهومه يعمّ الحلال منه والحرام؟ فهل الدخل الشخصي لفردٍ ما يسمّى رزقاً إذا كان مطابقاً للقوانين الأعم من الفقهية والعرفية، ومنطلقاً من الكسب الحلال والمشروع أم أن الدخل الشخصي يسمّى كذلك حتى لو أتى من أيّ سبيل كالغصب والسرقة، والمعاملات غير السليمة الخ.. فأيّ من هذين الرأيين في مسألة الرزق أقرب إلى الموقف الأشعري وأيّهما إلى الموقف الاعتزالي؟
يجيب سروش: إن المعتزلة يذهبون إلى أن الرزق هو الحلال فقط، فيما يعمّمه الأشاعرة إلى الحلال والحرام. فإذا كانت لدينا قراءة بَعدية تجريبية بعيدة عن المعايير المسبقة التي لا نريد إقحامها في الحكم، وهي معايير عيّنت سلفاً الحلال والحرام، فإننا سنقول: الدخل الاقتصادي يعمّ الحلال منه والحرام، بل ويشمل الملفّق منهما تماماً كما قال الأشاعرة. أما لو أردنا النظر من الأعلى إلى هذا الموضوع، وهدِفنا الشروع من التعاريف والكلّيات، وأردنا تحديد وظائف الأشياء من منطلق عالم العقل والتعريف، ثم ممارسة حركة توفيقية بين ما توصّلنا إليه وما هو في العالم الخارجي، فإننا سوف نعرّف الرزق في البداية، ثم نقوم باختيار ما يأتي تحت هذا التعريف من مصاديق له في الخارج، لنقصي البقية عقب ذلك.
من هنا يصل سروش إلى مسألةٍ أكثر جديةً ترتبط باختلاف وجهات النظر بين الأشاعرة والمعتزلة، هي مسألة الحسن والقبح الذاتيين أو الحسن والقبح العقليين. فعندما يقول المعتزلة: إن الفعل الفلاني له حسن وقبح ذاتيان، فإنهم يعنون أن هذا الفعل إما حسن أو قبيح، بمعنى أن العقل -في مقام الإثبات أو المعرفة- يمكنه أن ينتقي أحدها ويلغي الآخر.
كان الأشاعرة ينظرون إلى التجربة العملية ونتائجها المباشرة، فيقولون: إن الكذب قبيح لأنه يحمل مضارّ في الجانب العملي والتجريبي، فيما يقابل الصدقُ الحسنَ؛ لأنه ذو فوائد عملية وتجريبية، وهذا الموقف موقفٌ تجريبي عملاني، وعلم الأخلاق الذي يتجه اليوم إلى التجريبية يمرّ تقريباً عبر هذا المسير.
ثم يبحث سروش في مسألة الكليات ويذهب إلى أن المدرسة الأشعرية عموماً مدرسة اسمية، أي الذين يقصرون نظرهم على الأفراد ثم يقومون بجمعها لينالوا -عبر ذلك- الحكم الكلّي.
بحث العلية
وهناك مثالٌ أكثر دلالةً، ألا وهو بحث العلية، فالأشاعرة غير قائلين بالعلية العرضية والطبيعية في هذا العالم، وهذا بالضبط موقف تجريبي في مسألة العلية، ويدعو سروش إلى مراجعة كتاب «مقاصد الفلاسفة» أو «تهافت الفلاسفة» للغزالي، لكي نرى كيف شيّد -وبقوّة وبلاغة- أدلّة نقد مبدأ العلية. إن أدلّة الغزالي كانت قريبةً جداً من أدلّة ديفيد هيوم. نعم، هناك فرق بين رأي الغزالي في هذا الموضوع ورأي هيوم، إذ يعتقد الأخير بعدم مفهومية علاقة الضرورة (Necessary Connection)، بل إن هذه الكلمة فاقدة للمعنى أساساً، فلا وجود لشيء اسمه الربط الضروري أو علاقة الضرورة. أما الغزالي فينفي وجود علاقة العلية في الخارج، وهذا هو ما ينتج القول بالتقارن، ذلك أننا لا نرى في هذا العالم سوى مقارنات وتوالي أحداث، وهذه المقارنات والمتواليات لو حدثت آلاف المرات فلن يمكنها أن تنتج وجود علاقة ربط ضروري بين أطرافها، ذاك الربط الذي يسمّى بمبدأ العلية.
والفلاسفة التجريبيون لا يقولون أكثر من هذا، بل إن الفلاسفة العقليين أنفسهم لا يرون أصل العلية نتاجاً لعملية تجربية بحتة، أما مبدأ العلية فقد أتى من خريطة مسبقة مرسومة عقلاً أسقطت على هذا العالم. يصرّح الأشاعرة بأن ما نراه في هذا العالم ليس عليّةً أو سببية، فهم يرجعون العلية لله سبحانه. كما يطرح سروش مسائل خلافية أخرى مثل قانون الترجيح بلا مرجح، ومعضلة العدل الإلهي، وغرضية الفعل الإلهي، ومقولة الجزء الذي لا يتجزأ، وإنكار الكرامات، وهي مسائل تحتاج إلى مناقشة مستقلة ومستفيضة.
ويخلص سروش إلى أن لدى المعتزلة نوعاً من المماهاة للإنسان وبلوّرة الأشياء وفقه، وبتعبير آخر أنسنة العالم، وعلى حدّ تعبير أحمد آرام: اعتبار الإنسان مقياساً والحساب عليه. فإذا ما اعتبرنا الله سبحانه مثل الإنسان تقريباً، وأفعاله كتلك الصادرة من الفاعل الإنساني، ثم رتبنا الأحكام الأخلاقية وغير الأخلاقية للإنسان عليها، عندئذٍ سوف تبدو بوضوح أكبر صعوبة الموقف وتعقيداته، ولهذا، يعتقد سروش أن فصل المذهب الاعتزالي عن الإنسانوية، ثم مصالحته مع النزعة التجريبية، سوف يساعد على تحوّله إلى مدرسةٍ مقبولة في عالمنا اليوم.
* باحث في الفكر العربي والإسلامي

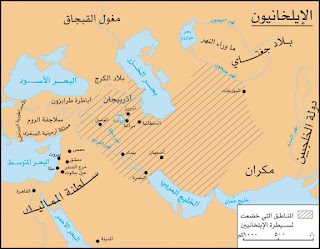
Comments
Post a Comment